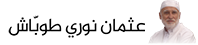يفكِّر الإنسان بالكلمات، ويوسِّع مجال تفكره باللغة؛ لذلك من المحال إيجاد طريق إلى آفاق التفكر الإسلامي بلغة قلَّت كلماتها وتبدلت معاني مفاهيمها.
يقول أحد المفكِّرين:
“إذا أردتَ أن تغيِّر قومًا، فغيِّر كلماتهم أولًا”. واليوم يُرَادُ أن تتبدل معاني مصطلحات الإسلام ومفاهيمها.
قد تظهر طائفة من الناس تعمل على استغلال المشاعر الدينية للناس، فيُساء إلى مفاهيم عظيمة كثيرة في الدين بسببهم، مثل “التصوف، والطريقة، والجماعة، والإمام، والخدمة، والهِّمة، والتسليم، والطاعة، والولاء”.
الجوهرة النادرة لا يسؤوها الطين عليها، ولا يحطُّ من قيمتها وصفائها، كذلك لا يمكن الإساءة إلى المصطلحات والمفاهيم التي تشكِّل حجر الأساس للتفكير الإسلامي بسبب الذين يجعلون الدين آلة لمطامعهم الدنيوية.
يحاول أهل الفتنة والفساد اليوم أن يلصِقوا كلَّ ما هو سيء على المفاهيم الجوهرية في الدين، ويُشَار إلى المسلمين بأصابع الاتهام بسبب حفنة ممن يستغلون الدين لمصالحهم وأهوائهم، فتمسي أفكارنا وأحاسيسنا أهدافًا لكل نية خبيثة مبيَّتة.
التصوف
لمفهوم “التصوف” مثلًا مكانة فريدة في ديننا، غير أنه مثل غيره من مفاهيم ديننا الحنيف تعرَّض لاتهامات شديدة.
أما الأساس في الاعتراضات على التصوف فهو قائم على سببين في أغلب الأحيان:
الأول: الجهل بحقيقة التصوف، والآخر: ما يظهر على بعض الجهلة ممن يدعون التصوف أو مَن هم ليسوا أهلًا لحمل رايته، فيكون ذلك ذريعةً لاتهام التصوف وأربابه.
مع أن التصوف ليس كما يُظهره أصحاب النيات الخبيثة، بل التصوف قيمة من قيمنا الأساسية التي تكوِّن هويتنا المعنوية. فالتصوف متجذر في كثير من البلدان الإسلامية، نشأ عليه جيل بعد جيل.
التصوف الحقيقي مدرسةٌ للتربية، ونظامٌ يحذِّر العبد مِن كل ما يبعده عن خالقه، ومنهجٌ يوصله إلى التقوى.
والتصوف ارتواءٌ من نبع التسليم لله تعالى، ورقيٌّ بالإيمان إلى درجة الإحسان.
والتصوف محاربة النفس حربًا لا هوادة فيها.
والتصوف تربيةٌ للنفس وتزكية لها وجعلها خاضعة للروحانيات.
والتصوف مسؤولية على المؤمن الساعي لمرضاة ربه تؤثِّر في قلبه فتجعله يلبي حاجات المخلوقات برحمة ورأفة.
والتصوف جعلُ القلب مأوى يطمئن فيه الناس جميعًا حتى مَن وقعَ في مستنقع الذنوب والآثام.
والتصوف تخلٍّ عن رغبات الدنيا عند الضرورة من أجل الآخرة، وتمسك بالآخرة ورفض استبدالها بالدنيا مهما كان الثمن؛ ذلك أن الحماقة أن يستبدل الإنسان البحر بقطرة.
والتصوف باب الفناء والقضاء على الأنا، لا البحث عن منصب أو جاه. وهو ملاذ لا يدخله الداخل إلا حين يُخرِج من قلبه مطامعه الدنيوية. وهو خضوع العبد لله تعالى مدركًا أنه فان. وهو معاملة عباد الله بخصال مثل العدل والصدق والرحمة والرأفة في سبيل نيل رضاه سبحانه، وجعل ذلك مبدأً في الحياة.
والتصوف سعيُ العبد لتطبيق ما جاء في الشريعة على أكمل وجه بتربية نفسه تربية معنوية. فالعبد لا يصل إلى الدرجة المطلوبة بالقراءة من السطور، بل بكمال أحواله المعنوية وتطهير قلبه من كل سوء؛ فالتصوف عيشُ شريعة طاهرة مُطهَّرة.
والتصوف القدرةُ على معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم حقَّ المعرفة، والاقتداء بشخصيته العظيمة وأخلاقه الحميدة في سبيل عيش الدين بصورة تليق بجوهره وروحه.
وكل شيء يعارض هذه المبادئ السامية ولا يستمد جوهره من الكتاب والسنة فهو باطل وإن عُزيَ إلى التصوف.
والتصوف إدراك العبد أنه عاجز مهما كان مقامه وموقعه. وهو طريق خلاصه من الأنا وإدراكه أنه فان بإخراج الغرور والكبر والأنانية من قلبه. وهو القدرة على عدم نسب أي نعمة أو نجاح إلى النفس، بل القدرة على قول:
“مِنكَ يا رب!”.
والتصوف عبودية لله سبحانه وتعالى والقلبُ “بين الخوف والرجاء”؛ أي الخوف من غضب الله تعالى، والرجاء في رحمته سبحانه.
والتصوف ليس تفاخرًا بالظاهر وعرضًا لما هو زائل، بل عيش بعرض الحال والتجاء إلى رحمة الله تعالى وعنايته وفي قلق من الأنفاس الأخيرة والآخرة. هو التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى.
فإذا كان الحال كذلك، فإنه من خبث النية أن يُوضَع التصوف والطرق الصوفية التي تمثل مدارس التربية الصوفية في الكفة التي تُوضَع فيها الفرق الباطلة التي لا تتوانى عن الاستخفاف بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه في سبيل المنافع الدنيوية.
لقد كان المتصوفة الحقيقيون مشاعل إرشاد تنير المجتمعات على مدى التاريخ. فعبد القادر الجيلاني وبهاء الدين نقشبند ومولانا جلال الدين الرومي ويونس أمره وعزيز محمود هدائي وأمثالهم من أولياء الله كانوا جميعًا ملاذًا للمجتمعات التي عاشوا فيها. لقد سعوا للحفاظ على الدين والإيمان والأمة من كل سوء، وكانوا في الصف الأول في مواجهة كل خطر وشيك. ولنا في الإمام الرباني أحمد السرهندي والشيخ خالد البغدادي خير مثال.
الجماعة
إن كلمة “الجماعة” في عالمنا المعنوي والذهني يدل على ذلك الاجتماع المألوف من أجل نيل رضا الله تعالى. فالمسلم لا يمكن أن يكون أنانيًا منعزلًا عمَّن حوله. وعلى المؤمن أن يكون فردًا من الجماعة دائمًا ومداومًا عليها ومتممًا لها.
إن ثواب صلاة الجماعة يزيد سبعًا وعشرين ضعفًا على ثواب صلاة الفرد. ولا يمكن أداء صلاة الجمعة وصلاة العيد إلا في جماعة. وعبادة الحج كمؤتمر اجتماعي للمؤمنين كافة.
فكل ذلك يبيِّن للمسلم أهمية الجماعة.
ومن مظاهر انعكاس شعور الجماعة في المجتمع أن يعلم المؤمن أنه مسؤول عن غيره، فتُقام الأوقاف والمؤسسات الخيرية بناء على هذه المسؤولية؛ فالجماعة وسيلة للرحمة في المجتمع.
لكن إن كان الاجتماع بقصد الفساد والتستر بغطاء الإسلام فذلك مرفوض وأمر يجلب غضب الله تعالى الذي يقول:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة، 2]
فنفهم من هذا أن التعاون على البر والتقوى والاجتماع من أجل زيادة الخير أمرٌ مقبولٌ، أما التعاون على الإثم والعدوان والاجتماع من أجل زيادة الشر فمرفوض.
لذلك يُعدُّ استحقار مفهوم “الجماعة” الذي له مكانة رفيعة في قلوب المؤمنين ووضع الجماعات الدينية كلها في كفة واحدة لوجود مَن يستغلون هذا المفهوم، إنما هو جريمة معنوية بحق المعنى الحقيقي للجماعة.
لقد ظهرت فِرق مختلفة تتحرك بمقاصد لا يرضاها الدين، ولبست عباءته على مدى التاريخ، فكانت ذريعةً لإعلان أن الجماعات الدينية والطرق الصوفية كلها “خطر”، غير أن الحقيقة أن اتهام الجماعات كلها ليس إلا مثل وضع “الديناميت” في الأسس المعنوية التي تقيم الأمة على قدميها.
فينبغي الوقوف في وجه مَن يتذرعون بأولئك الذين يستغلون إيمان الناس، فيعملون على توجيه ضربات تلو الضربات لتمزيق هوية “أهل السنة والجماعة” التي تشكل العمود الفقري للمسلمين. وينبغي التحرك بفراسة لإفساد خطة أعداء الدين.
فالسعي لرد الجماعة والطرق بدلًا من نقدها وإصلاحها إنما هو محاولة لاقتلاع جذر من الجذور المعنوية للمسلمين، ولا يُفرِح هذا الفعل إلا أعداء الإسلام.
ونجد من كل هذا أن التركيز على الأخطاء وجعلها ذريعة من غير السعي لفصل الصالحين من الطالحين إنما هو مشاركة في الجريمة.
لا بد هنا من الفصل بين الخير والشر والأبيض والأسود، وتجنب الخلط بين الصحيح والخطأ. فلا يمكن مثلًا أن نرفض علم الطب تمامًا لوجود أطباء يسيئون استعمال مهنتهم، ولا نرفض المحاماة لوجود محاميين يسيئون استعمال وظائفهم، ولا نستطيع أن نتهم جيشًا كاملًا لوجود مَن يتعامَل بينهم مع الأعداء.
وإنْ كان لا بد من مثال من التاريخ الإسلامي، فلنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قد أُمِر بالصلاة في مسجد قباء الذي أُسِّس على الإخلاص والتقوى ونُهِيَ عن الصلاة في مسجد ضرار الذي أسسه المنافقون على النفاق والفتنة. حيث نزل في ذلك قول الله تعالى:
{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَا اللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا و وَا اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة، 107- 108]
إذا نظرنا إلى المسجدَين في الظاهر، وجدنا أنهما صنوان، غير أننا إذا رأينا الوجه الحقيقي للمسألة، سنجد الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، والشرق والغرب. فمسجد قباء كان مسجدًا مباركًا يوحِّد قلوب المؤمنين ويطمئِنها، أما مسجد ضرار فمركز شر أقيم لزرع الفُرقة في أمة الإسلام.
وانطلاقًا من هذا المثال الذي يلخِّص حالنا اليوم فإن وظيفة المؤمن الذي ينظر إلى الأحداث من منظور إيماني ليست معارضة المساجد والجماعات والطرق الصوفية، بل معرفة مَن يتقنع بها معرفة نابعة من فراسة والوقوف في وجههم. أي الحفاظ على الأصيل وردُّ المغشوش، وعدم جعل القيم المعنوية لقمة سائغة لذوي النيات الخبيثة، وإلا كانت القرارات خاطئة والعاقبة وخيمة.
الإمام
تشير كلمة “إمام” بمعناها الأصلي إلى الأنبياء أولًا، ثم الأكابر الذين يسيرون على نهج الأنبياء ويوجِّهون الناس إلى طريق الحق والخير والهداية دائمًا بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم.
وأعظم أئمة المؤمنين نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلّم خاتم المُرسَلين، ذلك أنه الأسوة الحسنة للناس أجمعين. وهو المُسمَّى: “إمام الأنبياء”.
ويعلِّمنا الله سبحانه وتعالى بقوله:
{…وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان، 74] أن نكون من أهل التقوى ونمثِّل شخصية الإسلام التي تكون إمامًا لأهل التقوى.
وقد أوصى الشيخُ عزيز محمود هدائي رحمه الله الإمامَ الذي كان يؤمُّ الناس في المسجد الذي أوقفه بقوله: “أصلِحْ وأَرشِدْ”.
فينبغي ألا يُساء إلى المعنى الحقيقي لهذه الكلمة باستغلالها لأغراض شخصية.
الجهاد
إن مفهوم “الجهاد” الذي يُعدُّ من أكثر المفاهيم التي حُرِّفت في هذه الأيام إنما هو بذل جميع الإمكانات التي وهبها الله تعالى لنا في سبيل رضاه وإعلاء كلمة الإسلام في القلوب. فالتبليغ مثلًا “جهادٌ كبيرٌ” إذ يقول الله تعالى:
{فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} [الفرقان، 52]
فنزول أمر “الجهاد الكبير” في مكة والمؤمنون لا يملكون من القوة المادية لمواجهة المشركين يضع أعظم معاني الجهاد أمام أعيننا، وهو تبليغ القرآن الكريم بتطبيقه والعيش بمقتضاه.
ونفهم من هذا أن حصر مفهوم الجهاد في القتال بالسلاح هو تحريف لمعناه.
وليست الغاية من الجهاد في الإسلام سفك الدماء، بل فتح القلوب. والتضحية بالنفس عند الضرورة في سبيل الدفاع عن أرض المسلمين وحماية العرض والمحافظة على المقدسات إنما هي أيضًا جهاد. لكن تقديم هذا الجانب كمعنى وحيد للجهاد الذي يعني الخدمة في سبيل الله سبحانه وتعالى بكل الإمكانات، إنما هو تضييق لمعنى هذا المفهوم. وهذا رغبة مَن يريدون إبعاد الناس عن الإسلام بإظهاره على أنه “دين حرب”. ورهاب الإسلام أو ما يُسمَّى (الإسلاموفوبيا) الذي يُعَدُّ من أكبر فِتَن هذا الزمان إنما هو نتيجة تخريب الأذهان وتحريف معاني المفاهيم الأساسية.
الخدمة
إن المعنى الحقيقي للخدمة هو كل فعل حسن من أجل نيل رضا الله تعالى. فالرحمة أولى ثمار الإيمان، وأول مظاهر الرحمة “خدمة” مخلوقات الله سبحانه وتعالى في سبيل الخالق، ومشاركة المحتاجين بما في أيدنا من شتى أنواع النعم كي نعوِّضهم عمَّا هم محرومون منه.
أما إطاعة النفس والباطل بلبس عباءة الدين فلا يُمكن أن يُسمَّى “خدمة” البتة. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم:
{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف، 103- 104]
لذلك لا يُمكِن أن يُقال عن أي سعي لم يكن في سبيل الله “خدمة”. والخدمة الحقيقية كل فعل أتاه المرء في سبيل نيل رضا ربه.
الهِمَّة
الهمَّة في معناها الحقيقي “العون المعنوي”.
وطلبُ الهمة هو الطلب من الصالحين أن يكونوا وسيلة لحل المشكلات أو تحقيق أي غاية، وذلك يكون بالدعاء المستجاب منهم.
لكن ينبغي ألا ننسى هنا أن “التوفيق من الله”. فالله تعالى هو صاحب النعم كلها والمحسن على عباده والموفِّق. أما همَّة الصالحين أو دعاؤهم فليس إلا وسيلة. ولا بد من استجابة الله تعالى لأدعيتهم، فإن شاء الله قبِلَ دعاءهم. فالفاعل المطلق إنما هو الله سبحانه وتعالى.
الطاعة والتسلم والولاء
ينبغي ألا ننسى أبدًا أنه لا يمكن بلوغ غاية مشروعة بطريقة غير مشروعة. فلا يمكن إظهار الطاعة والتسليم أبدًا لمَن يبيحون ما حرَّم الله تحت اسم خدمة غايات سامية، فهذا ليس بطاعة بل عصيان، وسببٌ للهرج والمرج ووقوع المجتمع في الفتنة والفساد.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
“على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمَر بمعصية، فإن أُمِرَ بمعصية، فلا سمع ولا طاعة“. [مسلم، الإمارة، 38/1839]
لذلك ينبغي للمؤمن أن يجعل الكتاب والسُّنة مرجعًا له في كل شأن، ويقيِّم كلَّ أمر وتوجيه مِمَّن يتبعه على ضوء هذه الحقيقة. وعليه أن يخضع للحق ويجتنب الباطل دائمًا، ويعلم أن طاعة الباطل عصيان الحق، وأن طاعة أي أمر مخالف للكتاب والسنة- مهما كانت درجة الآمِر- هو عملٌ مخالف للإسلام، فالأصلُ حدود الإسلام لا الأشخاص.
لذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يُعَدُّ من خير الناس بعد الأنبياء، قال في خطبته بعد أن بُويعَ بالخلافة:
“أما بعد، أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن زُغتُ فقوموني”. (انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، جـ3، ص182)
وعن حذيفة رضي الله عنه قال:
دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين، فقال: هكذا بيده وأشار بها. قلت: الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرًا ننكره لقوَّمناك، قال: “اللهِ الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرًا تنكرونه لقوَّمتموه”، فقلت: اللهِ الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرًا ننكره لقوَّمناك. ففرح بذلك فرحًا شديدًا، وقال: “الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرًا ينكره قوَّمني”.(ابن أبي شيبة، مصنف، جـ7، ص99)
ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضع آخر:
“أحبُّ الناس إليَّ مَن رفع إليَّ عيوبي”. (سنن الدرامي، 1، 506)
فنفهم من هذا كله أنه لا أحد سوى الأنبياء معصومٌ عن الخطأ والتقصير وإن علا شأنه وارتفعت مكانته. ولا طاعة لأحد في شأن يخالف أمر الله تعالى.
نسأل الله تعالى أن يردَّ كيد كلِّ مَن يكيد لأمة الإسلام، وأن يبصِّرنا وينير قلوبنا ويعيننا على الحفاظ على قيمنا المادية والمعنوية، إنه الولي والقادر على ذلك….آمين!.