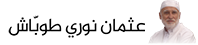لقد تحدثنا في كتاب “السلسلة الذهبية” عن أولياء الله الصالحين الذين ظهروا عبر التاريخ منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى وقتنا الحاضر. فكانوا نماذج “القدوة الحسنة” من العصور التي عاشوا فيها والتي تغذت معنوياً من رسول الله. وهم الممثلون لرسول الله صلى الله عليه وسلّم الشخصيةِ الفريدة المهداة للإنسانية جمعاء. فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلّم الذين عاشوا الإيمان بالعشق. هم أهل الحظوة الذين أوصلوا قلوبهم إلى قمة كمال الأخلاق والسلوك بالاغتراف من فيض النبي صلى الله عليه وسلّم. هم الشخصيات المثالية والقدوة المحتذى بالنسبة لمن لم يتشرف برؤية رسول الله وأصحابه الغر الميامين. هم بمثابة فروع الأخلاق النبوية المنتشرة والمفتوحة في مختلف الأزمنة والأمكنة. ومنبع فيض قلوبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
وإذا ما تمعنا ملياً في خلفية الأقوال المليئة بالحكمة، والأحوال الفياضة بالعبرة في قلوب تلك الشخصيات النموذجية وفي قصص حياتهم سنجد أنها كلها انعكاس من الأخلاق النبوية.
ومن الأمثلة على ذلك حاتم الأصم. إذ جاءت إليه ذات يوم امرأة مسكينة ضعيفة تسأله عن مسألة، فخرج منها في تلك الحالة صوت، فخجلت المرأة خجلاً شديداً فصارت وكأنها شمعة ذائبة من شدة الخجل. فما كان من حاتم إلا أن رفع يده إلى أذنه بكل وقار وهدوء وكأنه لم يسمع شيئاً، وقال لها: “لا أسمعك فارفعي صوتك”.
وأراها من نفسه أنه أصم. فسُرَّت المرأة بذلك وعادت إليها الروح من جديد حيث ظنت أنه أصم لا يسمع.
ونتيجة لهذا السلوك الرفيع الذي لم يُر له مثيل في أدب التعامل والمعاشرة لدى أمة من الأمم أطلق عليه لقب الأصم. إذ أنه بعد هذه الحادثة أظهر للناس أنه لا يسمع حتى لا تشعر تلك المرأة بالخجل إن سمعت أنه ليس بأصم. ولكنه بعد وفاة المرأة قال لمن حوله:
أذناي تسمعان، ولكم التحدث بصوت منخفض!
وتعالوا لننظر أيضاً إلى هذه الحادثة من عصر السعادة؛ إذ نجد فيها سلوكاً قل نظيره في اللطف وحسن التعامل:
كان عمر رضي الله عنه في بيت مع جماعة من الناس، ومعه جرير بن عبد الله البجلي، فوجد عمر ريحاً. فقال: “عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ”
فقال جرير: يا أمير المؤمنين! أو يتوضأ القوم جميعاً. فقال عمر الذي أعجب بهذا السلوك والتفهم الرفيع:
“رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية، نعم السيد أنت في الإسلام”.(علي المتقي، كنز العمال، رقم: 8608)
فكما يتبين لنا مما سبق فإن اللطف وحسن والتعامل والذوق الرفيع الذي أبداه حاتم الأصم هو انعكاس للأخلاق النموذجية التي تحلى بها رسول الله وأصحابه الذين رباهم أحسن تربية. وواحدة من الأمثلة على تلك الأخلاق الجميلة المنتشرة على مر الأزمنة.
ويعبر السري السقطي وهو من كبار أولياء الله عن ندمه الشديد من لحظة غفلة وقع فيها عندما لم يشعر بألم وخسارة أخيه في الدين، وحيث يقول:
“كان لي دكان في بغداد فيه متاع لي، فاحترق السوق فلقيني رجل فقال: أبشر! دكانك سلمت. فقلت: الحمد لله، ثم فكرت فرأيتها خطيئة. أي أنني فكرت في نفسي دون أن أفكر بإخوتي الذين احترقت دكاكينهم. وأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة”.
ومن الأمثلة الأخرى:
ذات يوم قال أحد التلاميذ ممن كان يقوم ببعض شؤونه: لقد حضرت بعض اللحم، ألا ترغب في أكله معي؟. ولما سكت داوود الطائي قام التلميذ فجاء باللحم ووضعه أمامه. إلا أن داوود الطائي نظر إلى اللحم الموضوع أمامه، وقال: “يا بني! ما أخبار اليتامى – مشيراً بذلك إلى بعض اليتامى الذين يعرفهم – ؟”. فقال التلميذ بصيغة تشير إلى سوء أحوالهم: كما تعلم يا سيدي! فقال داوود الطائي:
“إذاً؛ خذ هذا الطعام وأعطهم إياه!.”
فقال التلميذ المخلص الذي كان يرغب بشدة أن يتناول أستاذه من هذه الضيافة التي حضرها له: ولكن يا سيدي! لم تذق اللحم منذ مدة طويلة! وأصر تلميذه على رغبته. إلا أن داوود الطائي لم يقبل عرضه، وقال:
“يا بني! إذا أنا أكلت هذا اللحم فإنه لا يلبث أن يخرج مني، وأما إن أكله اليتامى فإنه سوف يصعد إلى العرش الأعلى حيث البقاء الأبدي!”.
فهذه هي أخلاق أولياء الله الصالحين في التضحية، والإيثار وتقديم إخوانهم في الدين على أنفسهم، ولا شك أن الأخلاق النبوية هي أساس هذه الأخلاق. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يكن يفكر بإشباع بطنه قبل إشباع جوعى أمته. ولم تكن تغمض له جفن حتى ينفق ما بيده من مال الدنيا. وكانت تلبية حاجة المحتاجين، وتفريج كرب المكروبين، وتسكين آلام المتألمين، وإشباع بطون الجائعين يمنحه متعة ولذة معنوية تنسيه آلام وجوع نفسه.
فقد جاء في الحديث الشريف:
“من لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم” (الحاكم، 4، 352؛ الهيثمي، 1، 87)
“ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه” (الحاكم، 2، 15/ 2166)
ومن مظاهر هذه الأخلاق النبوية الرفيعة، ما قاله جلال الدين الرومي:
“علمني شمس شيئاً (لكن نُقش في قلبي، وليس في عقلي)، حيث قال: ليس من حقك أن تتدفأ وفي الدنيا مؤمن يعاني من البرد. وأنا أعلم أن على وجه الأرض مؤمنون يعانون من البرد؛ لذا لا أشعر بالدفء أبداً!”.
فتلقي التربية على يد أمثال هؤلاء من الأولياء الذين حملوا الشخصية النموذجية لسيدنا محمد المبعوث ليتم مكارم الأخلاق إلى شتى أصقاع الأرض وفي سائر الأزمنة والعصور، لهو من أعظم النعم التي يمكن أن ينالها المرء في الدنيا. فبهذا الإحساس قال السلطان محمد فاتح الذي أنهى في التاريخ إمبراطوريات وأنشأ دولة عالمية جديدة، وأغلق الباب على مرحلة تاريخية وفتحه على مرحلة جديدة، ونال بشارة النبي صلى الله عليه وسلّم بفتح اسطنبول، قال يوم الفتح المبارك:
“ما ترونه علي من فرحة وسعادة ليست من مجرد فتح هذه القلعة فحسب، وإنما نابعة من وجود ولي مبارك وعزيز مثل آق شمس الدين في زمني وبصحبتي…”.
لأنه كان بدوره في موقع الممثل الكامل في ذلك العصر لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلّم النموذجية والقدوة.
فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال يوم فتح مكة رغم أنه قائد عظيم منتصر:
“لا عيش إلا عيش الآخرة“. حتى لا يصيبه الغرور، والكبر والزهو، والطغيان، والأنانية، ولا ينخدع بالدنيا فتتناقص رغبته بالآخرة؛ فإن آق شمس الدين كان شخصية نموذجية متشربة للشخصية النبوية وموزعها إلى آفاق اسطنبول.
فبعد صلاة الجمعة الأولى التي أعقبت فتح اسطنبول حضر آق شمس الدين احتفالات النصر التي أقيمت في ميدان أوق ميدان، ووجه وصايا ونصائح لذلك الجيش المنتصر. حيث حذرهم من الغفلة، ودعاهم إلى الشكر والحمد، والإنفاق، فقال:
“أيها المجاهدون! اعلموا أن نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام قد قال عنكم: “ولنعم الجيش ذلك الجيش“. ونسأل الله أن تكونوا جميعاً من المغفور لهم. وأدعوكم مقابل هذا الثناء الذي أثناه عليكم الرسول أن لا تسرفوا في أموال الغنائم، وتنفقوها في وجوه الخير والإحسان!”.
وبذلك فقد شجعهم جميعاً على بناء مؤسسات الخير لعمارة المدينة وتحقيق منافع الناس حتى فضل الجيش الذي فتح اسطنبول بفضيلة أخرى.
فكل هذا الذي ذكرنا يظهر أنه بإمكان المؤمنين الحقيقيين المتخلقين بالأخلاق النبوية تجسيد شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم القدوة الحسنة في مختلف العصور والأزمنة. وهذا الأمر يشمل عصرنا هذا وقابل للتحقيق فيه أيضاً.
وقد نجد أن لكل ولي من أولياء الله صفة مختلفة ومتميزة. لأن الحق سبحانه وتعالى الذي له حكمة في كل أفعاله خلق الكائنات كلها بصورة متميزة عن بعضها. ووهب عباده أيضاً خصائص مختلفة من الناحية المادية والمعنوية.
وكذلك فإن أولياء الله تعالى الذين اغترفوا من المنبع ذاته، أي من الكتاب والسنة يعكسون اختلافاً وتبايناً في مظاهر التجليات التي نالوها في عالم المعنى، مثلهم كمثل أجزاء قطعة الكرستال التي تعكس ألواناً مختلفة من الضوء ذاته.
فالبحار والمحيطات لا لون لها، وما الألوان التي تظهر عليها سوى انعكاسات مختلفة للضوء الذي تتلقاه من السماء. وحال أولياء الله كذلك ما هي إلا عبارة عن تظاهرات مختلفة لتجليات أسماء الحق سبحانه وتعالى في أنفسهم.
فمثلاً جعل الحق سبحانه وتعالى بعض الأولياء مثل الشاه نقشبند بحراً من الهمة التي لا نظير لها في التصرف المعنوي وفي معرفة الله سبحانه وتعالى؛ وجعل البعض بكماً صامتين أمام العظمة الإلهية وخصصهم بشاعرية الإرشاد بلسان الحال؛ وجعل البعض بلابل العشق الإلهي مثل يونس امره؛ بينما جعل البعض الآخر بحراً معنوياً واسعاً لا مثيل له تتدفق من ألسنتهم لآلئ الحكمة مثل مولانا.
وأما عبد القادر الجيلاني الولي الجليل فهو قبل كل شيء عالم ومرشد كامل عارف بالله. فهو من الشخصيات الاستثنائية التي أكرمها الله بطرح بركة تأثير عظيمة على إرشادهم المخلص حتى في يومنا هذا.
لقد كان كبار مشايخنا وعلمائنا يقرؤون ويتدارسون كتاب عبد القادر الجيلاني “الفتح الرباني” في مجالسهم. ويمكننا تلخيص بعض الرسائل التي نراها أنها أهم رسائل هذا الكتاب الذي نستعين به أيضاً في كتاباتنا ومجالسنا بالشكل الآتي:
– العلم واجب وضروري للغاية، ولكنه غير كاف وحده. إذ لا بد من تدعيمه بالعمل الصالح. والعمل بدوره غير كاف، وإنما من الضروري حفظه من الرياء وأدائه بإخلاص.
– لتحويل العلم إلى عرفان لا بد من خضوع النفس للتزكية. فمهما كان لدى المرء من علوم، حتى لو بلغت مبلغ البحار، فإنها معرضة لخطر التسمم. فنحن نرى حالة التسمم لدى قارون، ولدى بلعام بن باعوراء ظاهرة للعيان. فرغم أنهما كانا عبدين صالحين، إلا أن ميلهما لنفسيهما أصابهما بالتسمم والفساد. إذاً؛ إن كل مؤمن ملزم بحفظ ذاته من شر النفس. أي أن تزكية النفس من أهم وأولى المسائل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم:
“المجاهد من جاهد نفسه” (الترمذي، فضائل الجهاد، 2/1621)
وكذلك نجد أن عبد القادر الجيلاني توقف على مسألة “التوحيد” كثيراً. وفي الحقيقة تُعد العقائد من أكثر مسائل الدين حساسية ودقة. لأن عقيدة التوحيد لا تتحمل الإشراك أبداً. فالعقائد لا تقبل التهاون أو الاستهتار بشكل من الأشكال.
كل مؤمن ملزم بحفظ وحماية عزة الإسلام، وكرامته، وهيبته، ووقاره. ولهذا فعليه الابتعاد عن التشبه بأهل الضلال، وتجنب التآلف مع أهل الكفر والغفلة. ويسعى جاهداً لصحبة الصالحين والصادقين والاستفادة المعنوية منهم.
على المؤمن أن يكون في كل امتحان متمسكاً بالإيمان بصدق، وأن يظهر الرضا بالتقادير الإلهية، ولا يشعر بالحاجة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يستغني عن الفانين، وأن يكون همه الآخرة لا الدنيا. وأن يكون بحالة الزهد والرياضة القلبية تجاه الدنيا. وأن يحذر من الغفلة والشهوات والأهواء. وأن يكون مرتبطاً بالقرآن والسنة في سائر أحواله وتقلباته. وأن يفر من الحرام كما يفر من النار، ويكون كسبه ومأكله ومشربه من الحلال. وأن يحذر من البخل، ويتحلى بالكرم والتضحية. وأن يبتعد عن الإسراف، والتباهي بالمال والقوة، ويتحلى بالتواضع وخفض الجانب.وكذلك ينبغي على المؤمن أن يدرك أهمية وقيمة الوقت جيداً، فعليه المبادرة إلى التوبة وإصلاح حاله قبل حلول الأجل، وأن يسعى جاهداً لقضاء ما تبقى من عمره بالعمل الصالح.
والحاصل، يمكننا القول أن الرسائل الأساسية في كتاب شيخنا عبد القادر الجيلاني هي تطبيق الإسلام بحس التقوى وبحالة من العشق والوجد.
وعن أولياء الله الذين عرفهم هذا العصر-سامي محمود أفندي، ووالدي موسى أفندي- هنالك الكثير من الذكريات التي يمكن الحديث عنها في هذا المجال. ولكن الأمر الذي أود الحديث عنه أولاً هنا هو الأفق الواسع والفسيح من الرحمة والشفقة لدى أولئك الرجال الكبار. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول:
“التراحم، ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة“.(الحاكم، 4، 185/7310)
فإن كلاً من سامي أفندي، وموسى أفندي كانا بمنتهى الرحمة والشفقة تجاه كافة المخلوقات، وكانت هذه الرحمة ظاهرة بادية للعيان. وكانا يتعاملان بالرفق والرحمة والشفقة بمبدأ الرحمة بالخلق في سبيل الخالق، وأنقل إليكم بعضاً من آداب وحساسية سامي أفندي وموسى أفندي بخصوص الأضحية:
فقد كان سامي أفندي والمرحوم والدي موسى أفندي يتصرفان بغاية الحذر والحساسية عند ذبح الأضحية.
حيث كانا يسقيان الأضحية الماء، ولا يأخذانها إلى مكان الذبح بالدفع والجر. فإن كانت الأضحية من الشياه يأخذاها باحتضانها بكل لطف وشفقة. كما يغطيان عيني الأضحية. ولا يذبحا أضحيتين في نفس المكان، بل ينظما حفرة لكل منهما ويذبحاها على التوالي. وكانا دقيقين في مسألة أن تكون الموس المستخدمة في الذبح غاية في الحدة. فكانا يرغبان بذبح الحيوان دون إلحاق أي أذى به.
لا شك أن هذه الحساسية كانت مظهراً من مظاهر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ورثته.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلّم مر برجل، وهو يجر شاة بأذنها، فقال:
“دع أذنها، وخذ بسالفتها” (ابن ماجه، الذبائح، 3)
ويروي ابن عباس رضي الله عنه:
أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم:
“أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها“. (الحاكم، 4، 257/ 7563)
وكان كل من سامي أفندي، وموسى أفندي اللذين اتخذا من هذه التصرفات والحساسيات النبوية وأمثالها دستور حياتهما لا يجلسان على الكرسي أثناء ذبح الأضحية، وإنما كانا يقفان على قدميهما بحالة وجد العبادة حتى تدفق آخر قطرة دم من الذبيحة تعظيماً لأمر الله تعالى. كان يتفكران في نعم الحق سبحانه وتعالى، وهما بحالة الشعور بالعبودية والتذلل. وبذلك كانا يعلماننا بحالهم أن الأضحية أيضاً عبادة كبرى من ناحية التفكر والمعنى شأنها كشأن باقي العبادات، وعلينا الإيفاء بها بغاية الأدب.
ومن جانب آخر كان لهما الكثير من النماذج والأمثلة حول سعة رحمتهم وشفقتهم بالمخلوقات في سبيل الخالق. فمثلاً كان المرحوم والدي موسى أفندي يروي الحادثة الآتية:
بينما كنت في سفر مع سامي أفندي ذات يوم إذا برجل يقترب من السيارة في منطقة أورغوب ويطلب منه مالاً ثمناً لعلبة سجائر. ورغم الاعتراض الصامت منةبعض الأصحاب المرافقين إلا أنه لبى الرجل فأعطاه قائلاً:
“طالما أنه طلب، فما مِن بُدٍّ للتلبية!”، فأعطوه. ولكن الفقير الذي سر بهذا التصرف غير رأيه، حيث ابتعد قائلاً بفرح: سوف أذهب وأشتري بهذا المال طعاماً”.
فببركة النية الصادقة والمخلصة حرك ذلك المال المكتسب من الرزق الحلال، ميول الخير في قلب ذلك الرجل الذي أخذه. فتخلى عن شراء السجائر وقرر شراء الطعام عوضاً عنه.
إذاً علينا ألا ننسى أن المهم والمعتبر في أعمال الخير المنفذة لوجه الله تعالى هو الحالة القلبية لدينا، أكثر من الحالة القلبية لدى من يتلقى هذا العمل.
إلى جانب أنه إذا ما حللنا هذا المثال بعين القلب، فإنه سرعان ما يتبادر إلى الذهن حقيقة نبوية. فحسب ما ورد في حديث شريف أن رجلاً قال:
“قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله ” (البخاري، الزكاة، 14/ 1421؛ مسلم، الزكاة، 78/ 1022)
فهذه هي إحدى بركات النية الخالصة في عمل الخير، والرحمة والشفقة بالمخلوفات في سبيل الخالق…
وكانت الكياسة واللطف والإحساس المرهف في التعامل وخاصة في الإنفاق صفة استثنائية لدى والدي المرحوم موسى أفندي أيضاً. لأنه جاء في الآية القرآنية:
{… الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ…} [التوبة: 104]
ولهذا فإنه كان إذا ما أعطى زكاة أو صدقة أو هدية لأي إنسان، فإنه يقدمها بغاية اللطف. وكان يكتب على الظرف الذي يقدمه عبارات جميلة وظريفة، مثل “أيها … المحترم، أشكركم جزيل الشكر لتفضلكم بالقبول”. لأن الغاية كانت التمكن من الدخول إلى القلب الذي هو محل النظر الإلهي، ومن ثم الوصول إلى رضا الحق سبحانه وتعالى.
وكان أكثر جهده داخل العائلة منصباً على تعليم أبنائه كلام الله تعالى، وإعطائهم علوم القرآن، وتحبيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلّم. وكان يثني على من يقوم بخدمته، ويذكر بالحديث الشريف “سيد القوم خادمهم” (الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، رقم: 3473)
وكان والدي يشير وبشكل دائم إلى أن الخادم يمكن أن يتقدم على المخدوم. لأن القلوب مفتوحة إلى الله تعالى. لذا كان يحث دائماً على الخدمة. وحتى في وقت قريب من وفاته كان يقول:
“ليتني أجد في جسدي قوة، فأتجول في القرى قرية قرية، وأوصيهم بطريق التقوى هذا”.
وقد كان يهتم بأمور أمة محمد وهمومهم. فمثلاً كنا نذهب إلى أذربيجان فنمكث هناك أسبوعاً أو عشرة أيام ثم نعود. فكان ينتظرنا بلهفة حتى وإن وصلت الطائرة في ساعة متأخرة من الليل، وكنا ما إن نصل حتى يسرع إلينا، ويسأل: ماذا هناك من أحداث؟. فقد كانت هموم المسلمين همومه الشخصية.
عندما كنا نعمل في التجارة، كان هناك شخص يتردد كثيراً إلى محلنا، ويطلب المساعدة. وذات مرة قال له العامل:
لقد كان مجيئك قريب عهد، فقد أتيت بالأمس، وهذا الأمر مرفوضٌ!. فسمعه والدي من الداخل، فنادى العامل، وقال له:
“اسمع يا بني! نحن نطلب من الله باستمرار. ففقد تناولنا فطورنا صباحاَ، وسنطلب مجدداً طعام الغداء، وكذلك سنطلب طعام العشاء أيضاً. وأما هذا المسكين فإنه يأتيك ويطلب منك مرة كل يومين أو ثلاثة..”.
كان يطلب منا إعطاء شيء ولو يسير لكي لا يخرج السائل خاوي اليدين، وكي لا نعتاد عدم العطاء. إذ أن الله تعالى يخاطبنا من خلال رسول الله فيقول:
{وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [الضحى: 10]
وكان موسى أفندي إذا ما وعد وعداً فإنه ينفذه بكل تأكيد.
وبالطبع هذه الصفات من المزايا التي ينبغي أن يتخذها المسلم مثلاً له يحتذي به…
وكذلك الأمر في حياة موسى أفندي من حيث الترتيب والتنظيم العجيب. وكان هذا الأمر يسري على كل أحواله. فكان قلبه الرقيق يشعر بالضيق حتى من خيوط أطراف السجادة المفروشة للصلاة إذا كانت مبعثرة أو مطوية، فلم يكن يقف للصلاة حتى يصلحها.
وكل هذه الأمور ما هي في الأساس إلا مظهر من مظاهر ظرافة ورقة فخر الكائنات عليه الصلاة والسلام المنعكسة على أولياء الله تعالى. حيث أن هذا الأمر شبيه بموقف رسول الله الرافض للفوضوية وعدم الرتابة، وحبه للمظهر اللائق والذي يبدو جلياً في الحادثة الآتية:
بينما النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ذات يوم دخل رجل ثائر الرأس واللحية. فأشار إليه رسول الله بيده أن اخرج. كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل الرجل، ثم رجع. فقال رسول الله:
“أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟” (الموطأ، إصلاح الشعر، 4، 535)
والحاصل؛ إن كلاً من موسى أفندي، وسامي أفندي شأنهما كشأن غيرهما من أولياء الله الآخرين كانا من الشخصيات النجوم الذين اغترفوا من أخلاق رسول الله المثالية وأضاؤوا دروبنا بالمحاسن النبوية التي تمثلوها وبلغوها بأفعالهم وأحوالهم، لا بأقوالهم فحسب. فرضي الله عنهم أجمعين…
لقد تحدثنا فيما سبق عن القدوة الحسنة، واسمحوا لي للإشارة إلى الجانب السلبي -القدوة السيئة-… حيث أن هناك تحذيرات من قبيل “لا تكونوا كمثل هؤلاء” سواء في القرآن الكريم، أو الأحاديث النبوية الشريفة. وإذا أردنا أن نوجه في وقتنا الحالي تحذيراً، فما هي الأمور التي يمكن أن نقول لإنسان مسلم تجنب وجودها في شخصيتك؟
ينبغي أن تخلو شخصية المسلم من المعاصي الباطنية كما الظاهرية. فنحن كمسلمين نبتعد بشكل عام عن المحظورات الظاهرية. لأن هذه المحظورات عيوب ونواقص من شأنها أن تنعكس إلى الخارج، وقابلة للرؤية والملاحظة من قبل الآخرين. ولا يمكن أن يقبلها أي مسلم على نفسه. ولكن ليس من الممكن كثيراً قول الأمر ذاته بالنسبة للمحظورات الباطنية. لأنه ليس لهذه المحاذير جانب ينعكس إلى الخارج. ولهذا يمكن ارتكابها أكثر من الصنف السابق.
والحال أن هناك الكثير من الحرام الباطني الذي يُعد من الكبائر الأشد من الكثير من الحرام الظاهري في دين الله تعالى. فمثلاً ليس من السهل على المسلم أكل لحم الخنزير، ويعتبر هذا الفعل من أعظم الذنوب. بينما المسلم الذي يحذر من فعل هذا بشدة، يتعامل بحذر أقل مع التكلم في غيبة أخيه المسلم، أي يرتكب معصية الغيبة رغم علمه أنها معصية كبيرة بمثابة أكل لحمه ميتاً.
ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
{وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ…} [الأنعام: 120]
{… وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ…} [الأنعام: 151]
ويلفت أبو الحسن الخرقاني إلى غفلة عموم الناس تجاه الذنوب الباطنة فيقول:
“إذا تطايرت شرارة نار من التنور على ثيابك فإنك تسارع إلى إطفائها!إذاً؛ فكيف لك أن تسمح بوجود النار، مثل الكبر، والحسد، والرياء التي تحرق دينك في قلبك؟!”. (الخرقاني، نور العلوم، ص، 239)
إن الغيبة والنميمة محاولة نابعة من الكبر والأنانية تهدف إلى استحقار الغير والرفع من شأن الذات. فكأن فاعلها يقول: إن فلاناً يفعل كذا، بينما لا أفعله أنا.
والغيبة حق من حقوق العبد التي سيدفع الفاعل ثمنها يوم القيامة إن لم يسامحه من وقع عليه الفعل. فكما جاء في الأحاديث النبوية فإن كل الذنوب تُغفر لمن أحيا شهر رمضان إلا ما تعلق منها بحقوق العباد، فهي مستثناة من المغفرة. وحتى الشهيد تُغفر كافة ذنوبه إلا حقوق العباد.(راجع: مسلم، الإمارة، 119)
حيث سيتم أداؤها يوم القيامة. ففي ذلك اليوم يُؤخذ من حسنات المغتاب إن كان له حسنات، ويُعطى لمن وقعت عليه الغيبة؛ وإن لم يكن له حسنات، فيؤخذ من سيئات من ارتكبت الغيبة بحقه وتُلقى على المغتاب.
ولهذا يُحث الناس على طلب الصفح والتسامح والتحلل فيما بينهم، حيث ورد في أحد الأحاديث النبوية:
“أيها الناس، من كان عنده شيء فليؤده، ولا يقل: فضوح الدنيا، ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة“. (ابن الأثير، الكامل، 2، 182)
والأمر الآخر هو أنه:
ينبغي على المسلم عدم التكبر أبداً. فلا يستحقرن أحداً من عباد الله، فإنه كبيرة تهلك الإنسان في الآخرة. حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
“بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم” (مسلم، البر، 32/ 2564)
فمثلاً يقوم صاحب العمل أحياناً بتوبيخ العامل لديه، ولا يستطيع العامل الرد حتى وإن كان محقاً. لأنه يعلم أنه إن رد فإن سيجد نفسه خارج باب مكان عمله. فعلى المؤمن أن يعلم ويدرك دائماً وأبداً أن امتلاكه القوة أو المنصب لا يمنحه الحق في احتقار من هم أضعف منه أو في مناصب أدنى منه أبداً. كما جاء في الآية القرآنية:
{… إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ…} [الحجرات: 13]
هناك عبارة “هيا أحضر لي كوباً من الماء بسرعة”، وهناك عبارة “هل لك أن تحضر لي كأساً من الماء من فضلك؟” تقال للمستَخدَم. وفي كلتا العبارتين تطلب ماء. ولكن الواحدة منها تحتوي على غلظة وفظاظة، والأخرى محفوفة باللطف واللين. وهذا الماء يحدث تأثيراً على الشارب بحسب الحالة الروحانية لمن جلبه، فالأول لا فائدة فيه، بينما الثاني يشتمل على الشفاء.
وبناء على ذلك علينا أن نضع أنفسنا مكان المخاطب دائماً. ومن ثم علينا أن نتصرف معه كما نحب أن يتصرف معنا. فإن أردنا أن يولي لنا الغير أهمية، فعلينا أن نولي نحن أيضاً أهمية للآخرين. ولكن مع الأسف هناك الكثير من أصحاب المال اليوم لا يفكرون بهذه الطريقة.
والطامة المهمة والخطيرة الأخرى هي الهوس بالمباهاة، والإسراف… مثل الهوس بالمنازل الفاخرة المزودة بأحواض السباحة، والسيارات الفارهة، والثياب ذات العلامات المسجلة (الماركات) المعينة وغيرها. والحال أن الإسرا ف حرام. فقد جاء في القرآن الكريم:
{إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ … } [الإسراء:27]
فالإسراف محاولة لتجنب الشعور بالنقص بإظهار القوة. محاولة لإعطاء الذات أهمية وقيمة في نظر المجتمع عن طريق المال والأملاك، واللباس والهندام والمظهر الخارجي. والحال أن من يضفي القيمة على الإنسان هو شخصيته وطباعه. فالذين يحاولون جعل أنفسهم مقبولين في نظر الآخرين وإضفاء القيمة على أنفسهم من خلال الإسراف والقوة المادية والمالية، يبقون وحيدين في قبورهم عند وفاتهم. ويختفي المحبون والمحتفون بهم لأموالهم، وقوتهم ومناصبهم لا لشخصهم فور اختفاء هذه المظاهر. أي أن الذين كونوا أحباء وأصحاب بمظاهر الإسراف والتبذير والقوة يبدؤون بمواجهة عقاب معاصيهم وذنوبهم قبل الآخرة.
كان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا:
“يا أصحاب العلم؛ قصوركم قيصرية، وبيوتكم كسروية، وأثوابكم ظاهرية، وأخفافكم جالوتية، ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية، ومآثمكم جاهلية، ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟!”.
وليس من أخلاق المسلم الشح، والبخل وجمع المال للذات فقط. فقسم كبير من المسلمين في عالمنا اليوم الذي يئن من الألم، والمرض، والجوع والحاجة قد حصروا اهتمامهم ورصدوا كل إمكاناتهم وأموالهم في سبيل تحقيق الرفاهية والسعادة لأنفسهم دون التفكير بتقاسمها مع الآخرين، فتحولوا بذلك إلى عبادة المال. وهذه علامة على ذبول العاطفة وسُبات الضمائر لديهم.
وكذلك لا تليق بالإنسان المسلم الوقاحة، وقلة الحياء والأدب. حيث أن الأدب والحياء من الصفات التي خصها الله تعالى بالإنسان. فليس لدى المخلوقات الأخرى مثل هذه الخاصية. وبطبيعة الحال فهذه المخلوقات ليست خاضعة للمساءلة والحساب. ومن ثم على المؤمن الالتزام بالأدب والحياء في نظره، وسمعه، وحديثه، ومشيته، وقيامه وقعوده، وثيابه، وباختصار أن يكون ذا أدب وحياء في سائر أحواله وتقلباته.
والحاصل؛ إن هناك الكثير مما يقال في هذا المجال. ولكن إن أردنا الاختصار فيمكننا القول:
لا مكان في شخصية المسلم لأي سلوك أو فعل لا يليق ولا يتناسب مع أخلاق الإسلام. وخاصة الكذب، والحسد، والبغضاء، والمخاصمة، والتجسس، والظلم، والعدوان، والقسوة، والاضطهاد، والأنانية، والرياء، والجشع وغيرها من الخصال المذمومة.
ينبغي أن يكون المؤمن “إنسان رحمة” يأمن الناس من يده، ولسانه، وحاله ومقاله، ويكون مصدر نفع وفائدة لهم في كل ذلك. وإلا فإن آثار ونتائج حاله وسلوكه وأفعاله السيئة الخاطئة لن تقتصر عليه وحده، وإنما ستمتد إلى الإسلام الذي ينتمي إليه، فيحط من قدره واعتباره في نظر الناس، ومن ثم سينقلب الأمر وبالاً عليه في الآخرة.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لأن نكون سفراء رحمة، وأمة خير، وأن ييسر لنا تمثيل الإسلام وتبليغه بأحوالنا وأفعالنا بما يليق بسيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. آمين!..